تمهيد:
ينطلق الراحل السوسيولوجي بول باسكون في دراسته المنشورة في مجلة "لاماليف"، العدد 120، نونبر 1980، حول ''نظام فيودالي أم نظام قائدي بالمغرب'' ، من نقاش عميق حول الخصوصية التاريخية للنظام القائدي بالمغرب. فكيف تناول هذا النقاش؟
يتمثل هذا النقاش في إشكال كبير حول علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر في فحص خصوصية النظام الاجتماعي المغربي، وسنحاول أن نتعرض لهذه الإشكالية على ضوء ما يناقشه الباحث المغربي بول باسكون في دراسته القيمة...
النظام الاجتماعي بالمغرب بين الفيودالية والقائدية:
يعترض بول باسكون في بداية نقاشه على الأطروحة القائلة بأن علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر مرتبطة بنمط الإنتاج الفيودالي الشبيه، إلى حد ما، بالفيودالية الأوربية. ليدافع الراحل بول باسكون عن التصور القائدي على ضوء الذكريات التاريخية والمعلومات التي جمعها من منطقة مراكش، باعتبار هذه المنطقة كانت مختبرا سوسيولوجيا بالنسبة لبول باسكون، التي استفاد منها كثيرا في أبحاثه الميدانية، ولاسيما في منطقة الحوز التي عرفت النظام القائدي. يشار في هذا الجانب إلى أن القائدية من وجهة نظر بول باسكون تشير إلى التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية المغربية في القرن التاسع عشر، واصفا في كتاباته الأخرى، وبالضبط في الفصل الثالث والأخير "الهيمنة الرأسمالية" من أطروحته المركزية "دراسات قروية" بأن نمط الإنتاج لمنطقة الحوز في بداية القرن التاسع عشر كان يعتمد على الطاقة البشرية وبشكل محظوظ على الطاقة الحيوانية، أما الطاقة المائية فهي تقتصر على مطاحن الدقيق يملكها القواد والمخزن.
يميز بول باسكون النظام القائدي في منطقة الحوز بوجود تشكيلات مختلفة من قبيل: الرئاسة القبلية، السيادة المسلحة، القائدية المخزنية، القائدية العقارية، الخ... وبصدد هذه الأخيرة، فإن السوسيولوجي المغربي عبد الجليل حليم، يرى أنه لا يمكن فهم أشكال الأنظمة الاجتماعية والسياسية للتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية بالمجال القروي إلا بفهم تحديد وتحليل البنيات العقارية القائمة. مما يفرض مقاربة سوسيوتاريخية مادام نحن نتحدث هنا عن قرون ماضية، وذلك لرصد التطورات التي عرفتها هذه التشكيلات للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب، يقول بول باسكون: "إن هذه التشكيلات لا تسعى إلى هيكلة نشوء خطي عام صالح في كل مكان وزمان، بل تسعى فقط إلى عنونة وجمع سلسلة من الوقائع القائمة والتي يمكن التحقق منها في حقبة معينة وفي مكان بعينه، وبالتالي في سياق محدد"، رغم أن تاريخ المجتمع القروي هو تاريخ تصفية التنظيمات العفوية من قبل الدولة وإقامة تراتبيات إدارية مرتبطة وثيق الارتباط بالسلطة المركزية.
ويعتقد بول باسكون من خلال عدة استنتاجات في دراساته المتعددة حول مناطق كثيرة (الحوز، الغرب، الريف، سوس...) "أن التطور الواسع للدراسات المنتظمة والدقيقة والمطعمة بالوقائع والوثائق المثبتة علميا وحده الكفيل من إقامة نموذج نظام اجتماعي سياسي مغربي للقرن التاسع عشر".
وفي هذا الصدد، فإن باسكون يدعو الباحثين المغاربة إلى التحرر من الآراء المسبقة ومن الإيديولوجيات للوصول إلى دراسات علمية مثلما فعله الأوربيون أثناء دراساتهم للفيودالية الأوربية، باعتبار أن مختلف مناطق المغرب لم "تعش دائما وعلى نحو مضبوط نفس التاريخ"، ولاسيما إذا علمنا أن "المدة التاريخية التي استغرقتها الأشكال القائدية كانت في بعض المناطق منعدمة".
نقتنع هنا أكثر بوجود صعوبة في رصد الأنظمة الاجتماعية-السياسية السائدة في القرن التاسع عشر بالمغرب، وحيثما بول باسكون، يرفض مطابقة النظام القائدي المغربي بالنظام الفيودالي الأوربي، فإنه يستمر في استفزاز المهتمين بالموضوع لحثهم على البحث عن أجوبة لإشكال ما إذا كان المجتمع المغربي: مجتمع "فيودالي" أم قائدي؟
يذهب العديد من الباحثين السوسيولوجين إلى أنه ليس أحد أنماط الإنتاج المذكورة هو المهيمن، وإنما هناك مجموعة من الأنماط الإنتاجية التي ساهمت في بناء التشكيلة الاجتماعية المغربية والتي ينتج عنها بطبيعة الحال مجتمعا خاصا بها، بحيث نجد نمط الإنتاج الأبوي، القبلي، القائدي، الثيوقراطي، الايديولوجي، الطرقي...الخ, كتأكيد للمجتمع المزيج أو المركب الذي صاغه بول باسكون، وهو المجتمع الذي تتخلله خمسة نماذج اجتماعية بالمغرب: المجتمع اللاهوتي القائم على التضامن الديني الثيوقراطي، والمجتمع القبلي الذي يقوم على التضامن السياسي الترابي القبلي، والمجتمع القائدي التي تكون السلطة في يد القائد، بيد أن هذه القائدية أو المخزنية جعلت من هذا المجتمع شبيه بالفيودالية الذي يقوم فيه التضامن على الوصاية، أما النموذج الرأسمالي فيقوم على التضامن التقني الاقتصادي بقيادة المجتمع الآخر الذي هو المجتمع البطريكي، وهذا الأخير يترتب عنه التضامن القائم عن علاقات القرابة العصبية الأبوية. ويعتبر بول باسكون أن هذا التضامن الناتج عن القرابة هو أكثر الأشكال التضامنية هيمنة على الإطلاق، فيما التضامن الثيوقراطي يعتبر تضامنا عابرا، كما يذهب باسكون في كتاباته الأخرى إلى "أن نماذج عدة من التنظيمات الاجتماعية... تتصارع داخل هذا المجتمع، لسنا أمام مجتمع معين بل أمام مظاهر جزئية من مجتمعات متراكبة".
وإذا كان النظام الفيودالي في معناه البسيط هو نمط من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ظهر بأوربا خلال العصور الوسطى (ما بين 476م و1453م)، وتميز باختفاء مفهوم الدولة والمواطنة وسيادة تراتبية طبقية اجتماعية ذات بنية هرمية ضمت عدة فئات متفاوتة حيث كان يوجد على رأسه فئات الأسياد التي كانت تتوفر على امتيازات كبرى تتقاسم جزء منها الملوك، في حين شكل الفرسان أداة لجمع الضرائب واستغلال الأقنان في أعمال السخرة، ولحماية وضمان استمرار مكانة وامتيازات طبقة النبلاء/الأسياد، والذي كرس هذا النظام بطبعه تخلف أوربا لقرون عديدة، فما الذي يميزه عن القائدية المغربية، كتشكيلة اجتماعية واقتصادية مهيمنة على المجال القروي، وكامتداد للنظام المخزني المركزي؟
استنادا إلى الخطوط العريضة التي سطرها المرحوم بول باسكون في خلاصاته وتحليلاته لطبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسية التي تُميز وبشكل قاطع القائدية المغربية عن الفيودالية الأوربية، وكذا للدراسات الأخرى التي لا تقل أهمية عنها، فقد توصلنا إلى مايلي:
أن القائد في المغرب الذي يعتبر وسيطا بين القبيلة والمخزن، يعينه سلطان المخزن بواسطة ظهير شريف، كما يبايعه العلماء من الناحية الشكلية اللهم إذا حدثت تمردات وطموحات إلى السيادة كما هو الشأن خلال العهدين العزيزي ثم الحفيصي، على خلاف ما كان سائدا في الفيودالية الأوربية كشكل من الأنظمة الإقطاعية، حيث لا يهمه السيد –أي القائد- أن يحصل على أدنى دعم من الملك أو الحاكم، بحيث يستمد قوته من إقطاعيته ومن تضامن رعاياه المُوطعين في رئاسة إمارته المستقلة ذاتيا عن المركز. من ناحية أخرى، فإن ظاهرة الإقطاع لم تتطور إلا تطورا ضعيفا في المغرب وكانت شبه غائبة في القرن التاسع عشر حسب ما وصلتنا من كتابات حول الموضوع.
كما أنه من العناصر الأخرى التي تقول باستحالة الطابع الفيودالي في المجتمع المغربي، ولاسيما الجبلي منه، وجود الزاوية والقائدية، الديني والسياسي في تعايش قديم، يشتركان في تحققهما وشروط تواجدهما نقطة مشتركة في الغالب: غياب السلطة والفراغ السياسي أو العكس. أي نوعين من المواقف: الموقف المؤيد، والموقف الاستقلالي المعارض. إذن الوجود القائدي كحضور للسياسي كان يحده ويقيده الحضور الديني الشرعي الممثل في حضور الزاوية في كل صغيرة وكبيرة في حياة المجتمع المغربي المختلف عن المجتمع الفيودالي.
من جهة أخرى، إذا كان الأقنان هم فلاحون مرتبطون بأرض سيدهم ولا يملكون حرية مغادرته، كما لا يمكنهم الزواج ولا الإرث إلا بإذنه، كما كان سائدا في العديد من الأنظمة الفيودالية بأوربا، فإننا لا نجدهم في الظاهرة القائدية بالمغرب، اللهم خداما من العبيد أو "إسمغان" حسب اللسان الأمازيغي الذين كانوا في خدمة القائد، إضافة إلى خدمات اليهود المرتبطة به، وكذا هيمنته على المزارعين.
طبعا لم تتوطد العلاقة المقطعية بين العبيد والسيد مدى الحياة في الارتباط المطلق لخدمته، فالخادم كما يقول باسكون "ليس مدينا بأي شيء للسيد"، غير أن وفاءه يجب أن يكون شاملا وغير مشروط.
لاشك أن بول باسكون بحث كثيرا في الظاهرة القائدية بالمغرب كنظام لم يكن يغطي البلاد بأكمله، حيث إن غياب نمط إنتاج جامع وسائد بالمجتمع المغربي أدى إلى تدرج مراتبي لا يستند على دعامة مادية أو تضامن فئوي، بل يستند على أساس فوق طبقي تاريخي، زعماتي، فقهاوي، وشرفاوي... ومن هذا، فإن ممتلكات القائد المقُال تكون معرضة دائما للحجز.
ومن هذه التراتبية كذلك، مكنت القواد من تحقيق امتيازات ومكتسبات عقارية كبيرة، إضافة إلى استغلال سلطتهم لإستلاء على أراضي الغير، وكذا إجبار السكان على العمل فيها بشكل جماعي ومجاني، حيث صارت "تويزا" كلفة إلزامية وعقابا جماعيا يستغل لصالح القائد والباشا، فانتقلت وظيفتها التضامنية إلى طريقة تسخيرية ومصدرا للإثراء الفاحش كما هي موشومة في الذاكرة الجماعية، مما جعل روبير مونتاني في كتابه "البربر والمخزن" يقر بتواجد شُبه كبير بين النظام الاجتماعي السياسي (القائدي) المغربي السائد خلال القرن التاسع عشر والنظام الفيودالي الأوربي، ليخلص مونتاني في أطروحته إلى أن العداوة بين القبيلة والمخزن، عداوة بنيوية، نظرا لتعارض طموحاتهما، فالأولى تحلم باستمرار استقلالها الأزلي، والثاني يحلم بإنشاء إمبراطوريته تحت سلطة السلطان، ومن هنا يطرح مونتاني، تقابليات: بلاد السيبة/بلاد المخزن، القبيلة/المخزن، ديمقراطية العرف/استبداد الشرع، وتندرج هذه التعارضات عند مونتاني في مجالات التعارض بين الدولة والمجتمع، إلا أن الباحث المغربي بول باسكون يرفض أي تصنيف جاهز في خانة معدة مسبقا، ويفضل نحث كلمة جديدة التي تراعي الخصوصية المغربية رغم وجود دلائل مسبقة كثيرة تؤكد تلك العلاقة الإقطاعية أو الشبه إقطاعية/قائدية التي جسدتها تعسفات القواد المخزنيون.
لنسجل إذن فقط أنه لا يمكن تشبيه القائد بسيد فيودالي مادام وضعه من طبيعة مختلفة جذرية كما يرى إدمون عمران المليح في "مفهوم الدولة في المغرب" المنشور في مجلة "شعوب البحر الأبيض المتوسط" عدد يناير 1979. كتأكيد ما ذهب إليه كلود كاهن الذي رفض تشبيه البنية الاجتماعية المهيمنة حينذاك في المغرب بفيودالية على النموذج الأوربي.
صحيح، إن ممتلكات قائد مخزني مقُال معرضة دائما للحجز، حيثما يغادر الوظيفة لفائدة قائد آخر لا تضمن له أية هيئة امتلاكه للعقار، كما إن هذه الإقالة في غالب الأحيان تستتبع تلقائيا مصادرة ممتلكاته وحجزها، ذلك أن كل امتلاك عقاري يتم طوال مدة الخدمة المخزنية، بيد أن طول مدة الانتداب يتمتع فيها القواد بالأرض وبتملك عقاري من أجل تدعيم نفوذهم السياسي، لكن بشكل أقل بطئا مما كان عليه الفيودالي الأوربي باعتبار أن هذا القائد هو في آخر المطاف موظف للمخزن ويعمل تحت إمرته، ويمكن نقله إلى أي جهة كانت بالمغرب على خلاف السيد الفيودالي الذي كان يتمتع بسلطة خاصة، كما أن التركة في هذا النظام الفيودالي ظاهرة متأخرة واستثنائية مرتبطة بالخيانة والتمرد، في حين الملكية الخاصة مضمونة دائما في النظام الفيودالي على خلاف القائدي المخزني.
وإذا كانت ملكية الأرض كما أشارنا إليه هي من أهم مظاهر النظام الفيودالي، وحتى القائدي، وهي الخاصية التي ميزت الفيودالية الأوربية، حيث السيد والأقنان المشتغلين في أملاك السيد الشاسعة، واللوردات في النظام الفيودالي الأوربي يتعاقدون مع مستأجرين لاستغلال أراضيهم، في حين كانت الفئة التي تسمى بالرقيق كان عليها زراعة الأرض خدمة للورداتهم ، فإن هذا الوضع لم يكن كذلك في المجتمع المغربي، حيث لم يصل الأمر إلى درجة الأقنان. إن علاقات السيطرة المقننة التي تربط المشتغلين بالنبلاء والقواد والقائدية نفسها، لم تكن تذكر خلال القرن التاسع عشر بالمغرب، إلا في حالات نادرة جدا، حيث وجود ملكيات عائلية خاصة في غالب الأحيان لا تخضع للإقطاعي.
كما اقترنت الثروة في المغرب بالجماعة أو "رجماعث" حسب اللسان المغربي، غير أن الصلاحيات التي كان يتمتع بها شيوخ الجماعة وامتداد علاقاتهم خارج الإطار الطبيعي للقبيلة، جعلتهم محط اهتمام ومراقبة من طرف المخزن المركزي، الذي سيعمل على استقطابهم، وذلك بمنحهم التزكية القانونية والهيبة المخزنية، مما سيؤهله لتحقيق امتيازات ومكتسبات مادية مهمة، وبذلك تكون القبيلة قد أفرزت من ذاتها قائدا، سيضم تدريجيا إلى الهيكل أو الجهاز المخزني، وهي الفئة "الإقطاعية".
من هذا المنظور، في مقدورنا أن نفحص كيف تمكنت بنية اجتماعية ونمط إنتاج وعلاقات إنتاج للقبيلة من أن تظل ثابتة، وأخرى تعرضت للتحطيم في بنيتها الاجتماعية، كتمهيد في تصفية الاستقلال الذاتي القبلي من طرف المخزن، وبالتالي قد حولت قطب السلطة السياسية لصالح الدولة الممركزة.
إن السيرورة في عمقها معقدة وتتطلب دراسة مطولة بدون شك، لكن بوسعنا أن نجمع الزعامة والإقطاع ضمن تصور عريض لمجتمع فيودالوي، فإلى أي حد يشبه المجتمع القائدي، تقارن بتلك الأنماط الموجودة لدى النظام الفيودالي، يشير بول باسكون في هذا الصدد إلى أن أشكال العلاقات الاجتماعية في نموذجي المجتمعات التي تهمنا هنا –القائدية والفيودالية- ليست متقاربة كثيرا فيما بينها، ونفس الشيء يقال عن أشكال علاقات الإنتاج وأنماط الإنتاج، ذلك لأن هذا الأخير المميز والسائد في المجتمع المغربي غير الفيودالي كما يرى عبد الجليل حليم في مؤلف له: "البنيات الزراعية، من الإقطاع إلى الرأسمالية" أن هناك أنماط مباشرة وخالصة كنمط الإنتاج القائدي ونمط الإنتاج الإقطاعي الذي هو الفيودالي في القرن التاسع عشر، إضافة إلى أنماط إنتاج غير مباشرة تهم المجتمع القروي المغربي انطلاقا من طبيعة العلاقات السوسيواقتصادية السائدة بين المالكين والعاملين، وهذه الأنماط الإنتاجية غير المباشرة تتمثل حسب عبد الجليل حليم -طبعا ضمن العلاقات الاجتماعية والتعاقدات القائمة- في تخامست، ترباعت، تخبازت، تويزا,
أما بالنسبة للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المحددة لطبيعة وماهية الملكية العقارية في المغرب ماقبل الكولونيالية، كما أوردها عبد الجليل حليم على الشكل الآتي: أملاك الجماعة، الحبوس، المخزن، الإقطاع، ثم أملاك الملك (السلطان)، نجد سواد هذه الأملاك غائبة في النظام الفيودالي.
كما أن المؤسسة الاجتماعية العتيدة التي أبرزت الأنشطة الجماعية المشتركة هي مؤسسة الجماعة التي لها ثقل كبير داخل التنظيم القبلي وأثر على التعامل الاقتصادي والتعامل الاجتماعي بين الأفراد، يجعلها بمثابة المحرك الرئيسي للتناغم القبلي بالمغرب، وفي هذا يشير بول باسكون إلى أن الأرض -على سبيل المثال- في الكثير من مناطق المغرب كانت تمتلكها الجماعة التي كانت يمثلها نظام المخزن أو القبيلة حسب الظروف أكثر مما يمتلكها الأفراد.
واضح إذن من النظرة الأولى أن أسس علاقات الإنتاج في العديد من مناطق المغرب لها خصوصيتها الخاصة المميزة عن أنماط السائدة، إلى درجة أن بعض الباحثين يتساءلون عما إذا لم يكن المغرب قبل الاستعمار لا يرتبط بنمط الإنتاج الآسيوي الشهير جدا. فما هو أسلوب الإنتاج الآسيوي؟
من المعروف، أن مصطلح أسلوب الإنتاج الآسيوي مصطلح حديث نسبيا ظهر في القرن التاسع عشر، ويقصد به نمط الإنتاج الذي كان شائعا في الحضارات الإنسانية الأولى التي عرفها الشرق القديم وأعقب أسلوب المشاعية البدائية الذي عرفته البلدان الآسيوية والمشرقية عامة، وأساسه مشاعات ريفية يملكها حاكم واحد مستبد يعود إليه فائض الإنتاج ريعا عقاريا، تجمع بين الزراعة والصناعة اليدوية وتعتمد على الاكتفاء الذاتي وتخصيص بقطع من الأرض. فهل يتوافق هذا الأسلوب الآسيوي مع أسلوب نمط الإنتاج السائد في المجتمع المغربي أو لنقل في المجتمعات المغربية المركبة، ومع أنظمتها الاجتماعية والسياسية؟
يذهب روبير مونطاني، إلى أن النظام السياسي المغربي وإلى حدود الدخول الاستعماري، قد مر بأربعة مراحل أساسية يصنفها كالآتي: مرحلة الحكم الجمهوري الأوليغارشي والديمقراطي، مرحلة حكم الشيوخ أو الـ "إمغارن"، مرحلة حكم القواد الكبار أو ما يعرف بسادة الأطلس وأخيرا مرحلة حكم المخزن.
ومن خلال مقاربة سوسيوتاريخية لعلاقة السلطة المخزنية بالمجتمع في مغرب ما قبل المرحلة الكولونيالية، فقد شكلت القبيلة مجال نفوذ مشترك بين قوى سياسية ثلاثة: سلطة الزاوية، سلطة العامل أو القائد المخزني، سلطة المجالس القبلية. ولاشك إن كل هذه السلط والأنظمة لها خصوصيتها الخاصة في العلاقة مع أنماط إنتاجها، وتختلف عن الأسلوب الآسيوي، وأيضا عن الفيودالي. وبالتالي لا يمكن أن نأطر المغرب داخل خطاطة الأسلوب الآسيوي لأن مجتمع المغرب فيه كثير من الأنظمة الاجتماعية المتعددة التي تشكل المجتمع المزيج. على أية حال، لم يتفق الجميع مع هذا الارتباط بشأن العلاقة بين نمط الإنتاج الآسيوي والقائدي الذي يميز النظام المغربي في القرن التاسع عشر.
في نقد الخطاب العقائدي في إطار ابستمولوجية السوسيولوجي بول باسكون:
بعد استعرضنا لمختلف أنماط الإنتاج ومقارنتها بأنماط السائدة في المجتمعات المغربية، يبقى ضرورة وضع الدراسات التي ناقشت وعالجت نفس الموضوع أمام سلطة الابستيمولوجية لإصدار موقف علمي موضوعي حول مدى صحتها وحقيقتها، ومدى تطابقها واختلافها بصياغة تسلسل سوسيولوجي منهجي منسجم لرصد كل أنماط الإنتاج السائدة في المجتمع المغربي المركب والمزيج في إطار معرفة ما إذا كان القائد هو ماهية الظاهرة الاجتماعية المغربية وحقيقتها أم فقط هو الجهة التي ينظر إليه في هذا النظام. بل ويجب كذلك تنقيحها من الخطاب السياسي لإعطاء صفة العلمي في بلاغته، الشيء الذي يفرض بذل مجهود كبير للتفكير علميا كما يقول دائما صاحب "نطام فيودالي أم نظام قائدي بالمغرب"، خصوصا وأن خط السوسيولوجيا كانت في كثير من الأحيان موضوع مجابهات وصراعات خاصة ومتميزة، كما يرى الباحث السوسيولوجي المغربي محمد جسوس.
ومما لاشك فيه، فإن السيوسيولوجيا ارتهنت منذ نشأتها الأولى بمصدرين أو اختيارين متناقضان، بين دعاة أوغست كونت وبين الطرح الماركسي، يقول بول باسكون: "لا يوجد بالنسبة للعقائدي سوى اختيارين إثنين: إما شرح (أقوال) ماركس والتعليق عليها –بمعنى تفسيرها- وإما التموقع في معسكر المناقضين الذين تتعدد قناعاتهم". طبعا باسكون لا يرفض ولا يشك في المنهجية الماركسية إنما يحاول استخدامها وفقا لإمكاناته، وإن كانت كغيرها لا تحل كل شيء برأيه.
وإذا كان الباحث المغربي محمد جسوس في مقال 'عقائدي' له حول "وضعية البحث السوسيولوجي بالمغرب" يتسأل حول ما إذا كان بالإمكان بناء معرفة سوسيولوجيا في إطار مجتمع سياسي، ثقافي، إيديولوجي، يتسم في كل جزء منه بالعداء ليس فقط للسوسيولوجيا، ولكن لكل ما يمت للعلم والعقلنة بصلة، فإن بول باسكون، ينتقد بشدة هذا الطرح، كما سنرى، بل يذهب إلى أبعد من هذا، حين يقول: "بأن الأمر لا يتعلق بعلمين بل بخطابين ايديولوجيين لا يتوقفان عن تغذية آرائنا المسبقة ومفترضاتنا التي يجب الدفاع عنها باستمرار للحفاظ على توتر الجهد والشك". معنى هذا، يجب زعزعة هذه العقائد التي تدعي امتلاك الحقيقة وإلى احتكار للتأويل. وطبعا تجاوز هذه الثنائيات يتم عبر تبني مقاربات متعددة الأبعاد، حيث يقتضي ذلك التعدد النظري الذي يفيدنا في إنتاج سوسيولوجيا مرنة قابلة للتكيف وقادرة على المواكبة ومؤهلة لتحليل وتفسير تبدلات المجتمع.
يشير بول باسكون في مقام آخر، إلى انحراف يربك العلوم الاجتماعية بصفة عامة، وهو الانحراف الذي يجعل الحكم الذي نطلقه على الأفكار غامضا، وذلك عن طريق آراء مسبقة نُكونه عن الشخص، الذي يعبر عنها أو عن انتمائه المفترض وغيره. وبطبيعة الحال، هذا يذكرنا بقواعد المنهج لدوركايم التي يجب دائما استحضارها في الحقل السوسيولوجي كمناعة لا بد منها ضد "النزعة العقائدية" و"النزعة الضلامية" على حد تعبير بول باسكون.
وفي سياق آخر، يدعو الراحل المغربي بول باسكون إلى عولمة العلم -إذا صح تعبيرنا هذا- بمناهج علمية، وذلك بعدم الانغلاق داخل الجماعة التي ننتمي إليها في حبس وجهات نظرنا وتصورتنا فقط بالفروع المعرفية والنظريات السائدة في مجتمعنا، لأن بذلك سيكون "نهاية المعرفة" في رأي بول باسكون. وإنه، يجب كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار لمختلف وجهات النظر والتفتح على مختلف المدارس الفكرية العالمية والاستفادة من الفكر السوسيولوجي كله، دون تجاهل مساهمات السوسيولوجيين الكلاسيكيين أمثال كارل ماركس ودوركايم وبارسون...الخ.
لكن في المقابل، لابد لنا من مواكبة تلك الأطروحات التي تأسست على أنقاض تاريخ الجدل السوسيولوجي بين الوظيفية والبنيوية الوظيفية والاستفادة من أزمة الماركسية، حيث برز الآن توجه نحو التداخل النظري أو التعدد النظري، وذلك بالتقاط المقاربات الأجود مرودية من الناحية المعرفية، والاستفادة من هذا المنبع المعرفي في صياغة محاولات لأطروحات وأبحاث نظرية جديدة، وتوظيفها من الناحية الابستمولوجيا لإعطاء مشروعية علمية.
وهذا في رأينا، سيقلص من فجوة الأزمة التي تعيشها السوسيولوجيا، وسيساعد على فهم الإشكالات والأسئلة الكبرى التي تطرح من داخل الحقل السوسيولوجي، كما هو حال إشكال موضوع عرضنا هذا.
وهكذا، فمن خلال مختلف المقاربات النظرية والمنهجية والابستيمية الأكثر تخصيبا للمعرفة السوسيولوجيا نصل إلى التوجه الصحيح، الذي ينبغي للسوسيولوجيا أن تأخذه إزاء الرهانات الاجتماعية التي تواجه المجتمع. وفي هذا، يجب إغناء التأمل النظري المرتبط بالفكر السوسيولوجي المغربي، بإغناء تنظيره من دون التفريط في معطيات الواقع الاجتماعي أي بدون تعسف في استخدام المعطيات أو تسييسها بمبررات سياسية أو وطنية أو دينية... معنى هذا، يجب أن يكون رهين بتأسيس أفق ابستيمي واضح ودقيق ينسجم مع القوانين الاجتماعية العامة التي ثبتت صدقيتها، الذي يستلزم هذا طبعا تحقيق ذلك الحد الأدنى من القطيعة تجاه الذات وتجاه الجماعة التي ننتمي إليها للتوصل إلى الموضوعية والعلمية.
واضح إذن، أن على كل باحث، كيف ما كان، ينبغي عليه أن يتخلص من معالجة هذا الإشكال المتمثل في إرثه الثقافي والعقائدي، أن يقوم بعملية حفر معرفي للذات وإقامة مسافة أو حاجز بين الذات والموضوع، وهذه المسافة يجب أن تكون نقدية متحررة من عبودية وضعية وجاهزية الأفكار، حيث إنه في هذه العملية النقدية يسقط الفكر العقائدي، ونكون بذلك بعيدين عن الدوغمائية وأحادية الفكر والنمطية. وبالتالي أن ننطلق بأن ذواتنا قابلة للنقد ولا تمتلك الحقيقة الكلية المطلقة وأن ما تنتجه من المعرفة قابل للإشكال، قابل للاعتراض، أو أن الآخر متوهم وعلى ظلال إلى غير ذلك، وهذا يرجع إلى أننا لا نستطيع أن ننسلخ من ذلك الإرث العقائدي الذي يرثنا.
هكذا، يجب محاربة النزعة العقائدية والخطاب السياسي وتفادي الاختزال والتعميم، وبالطبع، فالوصول إلى هذا المطمح العلمي يقتضي الالتزام إلى درجة الأورثودوكسية بمجموعة من القواعد السوسيولوجية، فعلم الاجتماع من حيث هو تفكير في المجتمع وأنظمته يستلزم التباعد، أي يستلزم تحقيق الحد الأدنى من القطيعة تجاه الذات وتجاه الجماعة، فالموضوعية عند بول باسكون تعد شرطا غير قابل للتفاوض في رحاب السوسيولوجيا، فهي الضمانة الممكنة لأصالة ونزاهة المنجز السوسيولوجي، حتى لا يكون هناك تلويث الاستدلال عن طريق القدح الطبقي والوطني والعقيدي كما تعرض له الأب الروحي للسوسيولوجيا المغربية بول باسكون بصدد دراساته حول الأنظمة الاجتماعية في المجتمع المغربي المزيج، الذي كان في كثير من المقاربات ضحية هذا النوع من الخطاب الذي يدعي العلمية.
أكديم
ينطلق الراحل السوسيولوجي بول باسكون في دراسته المنشورة في مجلة "لاماليف"، العدد 120، نونبر 1980، حول ''نظام فيودالي أم نظام قائدي بالمغرب'' ، من نقاش عميق حول الخصوصية التاريخية للنظام القائدي بالمغرب. فكيف تناول هذا النقاش؟
يتمثل هذا النقاش في إشكال كبير حول علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر في فحص خصوصية النظام الاجتماعي المغربي، وسنحاول أن نتعرض لهذه الإشكالية على ضوء ما يناقشه الباحث المغربي بول باسكون في دراسته القيمة...
النظام الاجتماعي بالمغرب بين الفيودالية والقائدية:
يعترض بول باسكون في بداية نقاشه على الأطروحة القائلة بأن علاقات الإنتاج التي كانت سائدة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر مرتبطة بنمط الإنتاج الفيودالي الشبيه، إلى حد ما، بالفيودالية الأوربية. ليدافع الراحل بول باسكون عن التصور القائدي على ضوء الذكريات التاريخية والمعلومات التي جمعها من منطقة مراكش، باعتبار هذه المنطقة كانت مختبرا سوسيولوجيا بالنسبة لبول باسكون، التي استفاد منها كثيرا في أبحاثه الميدانية، ولاسيما في منطقة الحوز التي عرفت النظام القائدي. يشار في هذا الجانب إلى أن القائدية من وجهة نظر بول باسكون تشير إلى التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية المغربية في القرن التاسع عشر، واصفا في كتاباته الأخرى، وبالضبط في الفصل الثالث والأخير "الهيمنة الرأسمالية" من أطروحته المركزية "دراسات قروية" بأن نمط الإنتاج لمنطقة الحوز في بداية القرن التاسع عشر كان يعتمد على الطاقة البشرية وبشكل محظوظ على الطاقة الحيوانية، أما الطاقة المائية فهي تقتصر على مطاحن الدقيق يملكها القواد والمخزن.
يميز بول باسكون النظام القائدي في منطقة الحوز بوجود تشكيلات مختلفة من قبيل: الرئاسة القبلية، السيادة المسلحة، القائدية المخزنية، القائدية العقارية، الخ... وبصدد هذه الأخيرة، فإن السوسيولوجي المغربي عبد الجليل حليم، يرى أنه لا يمكن فهم أشكال الأنظمة الاجتماعية والسياسية للتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية بالمجال القروي إلا بفهم تحديد وتحليل البنيات العقارية القائمة. مما يفرض مقاربة سوسيوتاريخية مادام نحن نتحدث هنا عن قرون ماضية، وذلك لرصد التطورات التي عرفتها هذه التشكيلات للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب، يقول بول باسكون: "إن هذه التشكيلات لا تسعى إلى هيكلة نشوء خطي عام صالح في كل مكان وزمان، بل تسعى فقط إلى عنونة وجمع سلسلة من الوقائع القائمة والتي يمكن التحقق منها في حقبة معينة وفي مكان بعينه، وبالتالي في سياق محدد"، رغم أن تاريخ المجتمع القروي هو تاريخ تصفية التنظيمات العفوية من قبل الدولة وإقامة تراتبيات إدارية مرتبطة وثيق الارتباط بالسلطة المركزية.
ويعتقد بول باسكون من خلال عدة استنتاجات في دراساته المتعددة حول مناطق كثيرة (الحوز، الغرب، الريف، سوس...) "أن التطور الواسع للدراسات المنتظمة والدقيقة والمطعمة بالوقائع والوثائق المثبتة علميا وحده الكفيل من إقامة نموذج نظام اجتماعي سياسي مغربي للقرن التاسع عشر".
وفي هذا الصدد، فإن باسكون يدعو الباحثين المغاربة إلى التحرر من الآراء المسبقة ومن الإيديولوجيات للوصول إلى دراسات علمية مثلما فعله الأوربيون أثناء دراساتهم للفيودالية الأوربية، باعتبار أن مختلف مناطق المغرب لم "تعش دائما وعلى نحو مضبوط نفس التاريخ"، ولاسيما إذا علمنا أن "المدة التاريخية التي استغرقتها الأشكال القائدية كانت في بعض المناطق منعدمة".
نقتنع هنا أكثر بوجود صعوبة في رصد الأنظمة الاجتماعية-السياسية السائدة في القرن التاسع عشر بالمغرب، وحيثما بول باسكون، يرفض مطابقة النظام القائدي المغربي بالنظام الفيودالي الأوربي، فإنه يستمر في استفزاز المهتمين بالموضوع لحثهم على البحث عن أجوبة لإشكال ما إذا كان المجتمع المغربي: مجتمع "فيودالي" أم قائدي؟
يذهب العديد من الباحثين السوسيولوجين إلى أنه ليس أحد أنماط الإنتاج المذكورة هو المهيمن، وإنما هناك مجموعة من الأنماط الإنتاجية التي ساهمت في بناء التشكيلة الاجتماعية المغربية والتي ينتج عنها بطبيعة الحال مجتمعا خاصا بها، بحيث نجد نمط الإنتاج الأبوي، القبلي، القائدي، الثيوقراطي، الايديولوجي، الطرقي...الخ, كتأكيد للمجتمع المزيج أو المركب الذي صاغه بول باسكون، وهو المجتمع الذي تتخلله خمسة نماذج اجتماعية بالمغرب: المجتمع اللاهوتي القائم على التضامن الديني الثيوقراطي، والمجتمع القبلي الذي يقوم على التضامن السياسي الترابي القبلي، والمجتمع القائدي التي تكون السلطة في يد القائد، بيد أن هذه القائدية أو المخزنية جعلت من هذا المجتمع شبيه بالفيودالية الذي يقوم فيه التضامن على الوصاية، أما النموذج الرأسمالي فيقوم على التضامن التقني الاقتصادي بقيادة المجتمع الآخر الذي هو المجتمع البطريكي، وهذا الأخير يترتب عنه التضامن القائم عن علاقات القرابة العصبية الأبوية. ويعتبر بول باسكون أن هذا التضامن الناتج عن القرابة هو أكثر الأشكال التضامنية هيمنة على الإطلاق، فيما التضامن الثيوقراطي يعتبر تضامنا عابرا، كما يذهب باسكون في كتاباته الأخرى إلى "أن نماذج عدة من التنظيمات الاجتماعية... تتصارع داخل هذا المجتمع، لسنا أمام مجتمع معين بل أمام مظاهر جزئية من مجتمعات متراكبة".
وإذا كان النظام الفيودالي في معناه البسيط هو نمط من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ظهر بأوربا خلال العصور الوسطى (ما بين 476م و1453م)، وتميز باختفاء مفهوم الدولة والمواطنة وسيادة تراتبية طبقية اجتماعية ذات بنية هرمية ضمت عدة فئات متفاوتة حيث كان يوجد على رأسه فئات الأسياد التي كانت تتوفر على امتيازات كبرى تتقاسم جزء منها الملوك، في حين شكل الفرسان أداة لجمع الضرائب واستغلال الأقنان في أعمال السخرة، ولحماية وضمان استمرار مكانة وامتيازات طبقة النبلاء/الأسياد، والذي كرس هذا النظام بطبعه تخلف أوربا لقرون عديدة، فما الذي يميزه عن القائدية المغربية، كتشكيلة اجتماعية واقتصادية مهيمنة على المجال القروي، وكامتداد للنظام المخزني المركزي؟
استنادا إلى الخطوط العريضة التي سطرها المرحوم بول باسكون في خلاصاته وتحليلاته لطبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسية التي تُميز وبشكل قاطع القائدية المغربية عن الفيودالية الأوربية، وكذا للدراسات الأخرى التي لا تقل أهمية عنها، فقد توصلنا إلى مايلي:
أن القائد في المغرب الذي يعتبر وسيطا بين القبيلة والمخزن، يعينه سلطان المخزن بواسطة ظهير شريف، كما يبايعه العلماء من الناحية الشكلية اللهم إذا حدثت تمردات وطموحات إلى السيادة كما هو الشأن خلال العهدين العزيزي ثم الحفيصي، على خلاف ما كان سائدا في الفيودالية الأوربية كشكل من الأنظمة الإقطاعية، حيث لا يهمه السيد –أي القائد- أن يحصل على أدنى دعم من الملك أو الحاكم، بحيث يستمد قوته من إقطاعيته ومن تضامن رعاياه المُوطعين في رئاسة إمارته المستقلة ذاتيا عن المركز. من ناحية أخرى، فإن ظاهرة الإقطاع لم تتطور إلا تطورا ضعيفا في المغرب وكانت شبه غائبة في القرن التاسع عشر حسب ما وصلتنا من كتابات حول الموضوع.
كما أنه من العناصر الأخرى التي تقول باستحالة الطابع الفيودالي في المجتمع المغربي، ولاسيما الجبلي منه، وجود الزاوية والقائدية، الديني والسياسي في تعايش قديم، يشتركان في تحققهما وشروط تواجدهما نقطة مشتركة في الغالب: غياب السلطة والفراغ السياسي أو العكس. أي نوعين من المواقف: الموقف المؤيد، والموقف الاستقلالي المعارض. إذن الوجود القائدي كحضور للسياسي كان يحده ويقيده الحضور الديني الشرعي الممثل في حضور الزاوية في كل صغيرة وكبيرة في حياة المجتمع المغربي المختلف عن المجتمع الفيودالي.
من جهة أخرى، إذا كان الأقنان هم فلاحون مرتبطون بأرض سيدهم ولا يملكون حرية مغادرته، كما لا يمكنهم الزواج ولا الإرث إلا بإذنه، كما كان سائدا في العديد من الأنظمة الفيودالية بأوربا، فإننا لا نجدهم في الظاهرة القائدية بالمغرب، اللهم خداما من العبيد أو "إسمغان" حسب اللسان الأمازيغي الذين كانوا في خدمة القائد، إضافة إلى خدمات اليهود المرتبطة به، وكذا هيمنته على المزارعين.
طبعا لم تتوطد العلاقة المقطعية بين العبيد والسيد مدى الحياة في الارتباط المطلق لخدمته، فالخادم كما يقول باسكون "ليس مدينا بأي شيء للسيد"، غير أن وفاءه يجب أن يكون شاملا وغير مشروط.
لاشك أن بول باسكون بحث كثيرا في الظاهرة القائدية بالمغرب كنظام لم يكن يغطي البلاد بأكمله، حيث إن غياب نمط إنتاج جامع وسائد بالمجتمع المغربي أدى إلى تدرج مراتبي لا يستند على دعامة مادية أو تضامن فئوي، بل يستند على أساس فوق طبقي تاريخي، زعماتي، فقهاوي، وشرفاوي... ومن هذا، فإن ممتلكات القائد المقُال تكون معرضة دائما للحجز.
ومن هذه التراتبية كذلك، مكنت القواد من تحقيق امتيازات ومكتسبات عقارية كبيرة، إضافة إلى استغلال سلطتهم لإستلاء على أراضي الغير، وكذا إجبار السكان على العمل فيها بشكل جماعي ومجاني، حيث صارت "تويزا" كلفة إلزامية وعقابا جماعيا يستغل لصالح القائد والباشا، فانتقلت وظيفتها التضامنية إلى طريقة تسخيرية ومصدرا للإثراء الفاحش كما هي موشومة في الذاكرة الجماعية، مما جعل روبير مونتاني في كتابه "البربر والمخزن" يقر بتواجد شُبه كبير بين النظام الاجتماعي السياسي (القائدي) المغربي السائد خلال القرن التاسع عشر والنظام الفيودالي الأوربي، ليخلص مونتاني في أطروحته إلى أن العداوة بين القبيلة والمخزن، عداوة بنيوية، نظرا لتعارض طموحاتهما، فالأولى تحلم باستمرار استقلالها الأزلي، والثاني يحلم بإنشاء إمبراطوريته تحت سلطة السلطان، ومن هنا يطرح مونتاني، تقابليات: بلاد السيبة/بلاد المخزن، القبيلة/المخزن، ديمقراطية العرف/استبداد الشرع، وتندرج هذه التعارضات عند مونتاني في مجالات التعارض بين الدولة والمجتمع، إلا أن الباحث المغربي بول باسكون يرفض أي تصنيف جاهز في خانة معدة مسبقا، ويفضل نحث كلمة جديدة التي تراعي الخصوصية المغربية رغم وجود دلائل مسبقة كثيرة تؤكد تلك العلاقة الإقطاعية أو الشبه إقطاعية/قائدية التي جسدتها تعسفات القواد المخزنيون.
لنسجل إذن فقط أنه لا يمكن تشبيه القائد بسيد فيودالي مادام وضعه من طبيعة مختلفة جذرية كما يرى إدمون عمران المليح في "مفهوم الدولة في المغرب" المنشور في مجلة "شعوب البحر الأبيض المتوسط" عدد يناير 1979. كتأكيد ما ذهب إليه كلود كاهن الذي رفض تشبيه البنية الاجتماعية المهيمنة حينذاك في المغرب بفيودالية على النموذج الأوربي.
صحيح، إن ممتلكات قائد مخزني مقُال معرضة دائما للحجز، حيثما يغادر الوظيفة لفائدة قائد آخر لا تضمن له أية هيئة امتلاكه للعقار، كما إن هذه الإقالة في غالب الأحيان تستتبع تلقائيا مصادرة ممتلكاته وحجزها، ذلك أن كل امتلاك عقاري يتم طوال مدة الخدمة المخزنية، بيد أن طول مدة الانتداب يتمتع فيها القواد بالأرض وبتملك عقاري من أجل تدعيم نفوذهم السياسي، لكن بشكل أقل بطئا مما كان عليه الفيودالي الأوربي باعتبار أن هذا القائد هو في آخر المطاف موظف للمخزن ويعمل تحت إمرته، ويمكن نقله إلى أي جهة كانت بالمغرب على خلاف السيد الفيودالي الذي كان يتمتع بسلطة خاصة، كما أن التركة في هذا النظام الفيودالي ظاهرة متأخرة واستثنائية مرتبطة بالخيانة والتمرد، في حين الملكية الخاصة مضمونة دائما في النظام الفيودالي على خلاف القائدي المخزني.
وإذا كانت ملكية الأرض كما أشارنا إليه هي من أهم مظاهر النظام الفيودالي، وحتى القائدي، وهي الخاصية التي ميزت الفيودالية الأوربية، حيث السيد والأقنان المشتغلين في أملاك السيد الشاسعة، واللوردات في النظام الفيودالي الأوربي يتعاقدون مع مستأجرين لاستغلال أراضيهم، في حين كانت الفئة التي تسمى بالرقيق كان عليها زراعة الأرض خدمة للورداتهم ، فإن هذا الوضع لم يكن كذلك في المجتمع المغربي، حيث لم يصل الأمر إلى درجة الأقنان. إن علاقات السيطرة المقننة التي تربط المشتغلين بالنبلاء والقواد والقائدية نفسها، لم تكن تذكر خلال القرن التاسع عشر بالمغرب، إلا في حالات نادرة جدا، حيث وجود ملكيات عائلية خاصة في غالب الأحيان لا تخضع للإقطاعي.
كما اقترنت الثروة في المغرب بالجماعة أو "رجماعث" حسب اللسان المغربي، غير أن الصلاحيات التي كان يتمتع بها شيوخ الجماعة وامتداد علاقاتهم خارج الإطار الطبيعي للقبيلة، جعلتهم محط اهتمام ومراقبة من طرف المخزن المركزي، الذي سيعمل على استقطابهم، وذلك بمنحهم التزكية القانونية والهيبة المخزنية، مما سيؤهله لتحقيق امتيازات ومكتسبات مادية مهمة، وبذلك تكون القبيلة قد أفرزت من ذاتها قائدا، سيضم تدريجيا إلى الهيكل أو الجهاز المخزني، وهي الفئة "الإقطاعية".
من هذا المنظور، في مقدورنا أن نفحص كيف تمكنت بنية اجتماعية ونمط إنتاج وعلاقات إنتاج للقبيلة من أن تظل ثابتة، وأخرى تعرضت للتحطيم في بنيتها الاجتماعية، كتمهيد في تصفية الاستقلال الذاتي القبلي من طرف المخزن، وبالتالي قد حولت قطب السلطة السياسية لصالح الدولة الممركزة.
إن السيرورة في عمقها معقدة وتتطلب دراسة مطولة بدون شك، لكن بوسعنا أن نجمع الزعامة والإقطاع ضمن تصور عريض لمجتمع فيودالوي، فإلى أي حد يشبه المجتمع القائدي، تقارن بتلك الأنماط الموجودة لدى النظام الفيودالي، يشير بول باسكون في هذا الصدد إلى أن أشكال العلاقات الاجتماعية في نموذجي المجتمعات التي تهمنا هنا –القائدية والفيودالية- ليست متقاربة كثيرا فيما بينها، ونفس الشيء يقال عن أشكال علاقات الإنتاج وأنماط الإنتاج، ذلك لأن هذا الأخير المميز والسائد في المجتمع المغربي غير الفيودالي كما يرى عبد الجليل حليم في مؤلف له: "البنيات الزراعية، من الإقطاع إلى الرأسمالية" أن هناك أنماط مباشرة وخالصة كنمط الإنتاج القائدي ونمط الإنتاج الإقطاعي الذي هو الفيودالي في القرن التاسع عشر، إضافة إلى أنماط إنتاج غير مباشرة تهم المجتمع القروي المغربي انطلاقا من طبيعة العلاقات السوسيواقتصادية السائدة بين المالكين والعاملين، وهذه الأنماط الإنتاجية غير المباشرة تتمثل حسب عبد الجليل حليم -طبعا ضمن العلاقات الاجتماعية والتعاقدات القائمة- في تخامست، ترباعت، تخبازت، تويزا,
أما بالنسبة للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المحددة لطبيعة وماهية الملكية العقارية في المغرب ماقبل الكولونيالية، كما أوردها عبد الجليل حليم على الشكل الآتي: أملاك الجماعة، الحبوس، المخزن، الإقطاع، ثم أملاك الملك (السلطان)، نجد سواد هذه الأملاك غائبة في النظام الفيودالي.
كما أن المؤسسة الاجتماعية العتيدة التي أبرزت الأنشطة الجماعية المشتركة هي مؤسسة الجماعة التي لها ثقل كبير داخل التنظيم القبلي وأثر على التعامل الاقتصادي والتعامل الاجتماعي بين الأفراد، يجعلها بمثابة المحرك الرئيسي للتناغم القبلي بالمغرب، وفي هذا يشير بول باسكون إلى أن الأرض -على سبيل المثال- في الكثير من مناطق المغرب كانت تمتلكها الجماعة التي كانت يمثلها نظام المخزن أو القبيلة حسب الظروف أكثر مما يمتلكها الأفراد.
واضح إذن من النظرة الأولى أن أسس علاقات الإنتاج في العديد من مناطق المغرب لها خصوصيتها الخاصة المميزة عن أنماط السائدة، إلى درجة أن بعض الباحثين يتساءلون عما إذا لم يكن المغرب قبل الاستعمار لا يرتبط بنمط الإنتاج الآسيوي الشهير جدا. فما هو أسلوب الإنتاج الآسيوي؟
من المعروف، أن مصطلح أسلوب الإنتاج الآسيوي مصطلح حديث نسبيا ظهر في القرن التاسع عشر، ويقصد به نمط الإنتاج الذي كان شائعا في الحضارات الإنسانية الأولى التي عرفها الشرق القديم وأعقب أسلوب المشاعية البدائية الذي عرفته البلدان الآسيوية والمشرقية عامة، وأساسه مشاعات ريفية يملكها حاكم واحد مستبد يعود إليه فائض الإنتاج ريعا عقاريا، تجمع بين الزراعة والصناعة اليدوية وتعتمد على الاكتفاء الذاتي وتخصيص بقطع من الأرض. فهل يتوافق هذا الأسلوب الآسيوي مع أسلوب نمط الإنتاج السائد في المجتمع المغربي أو لنقل في المجتمعات المغربية المركبة، ومع أنظمتها الاجتماعية والسياسية؟
يذهب روبير مونطاني، إلى أن النظام السياسي المغربي وإلى حدود الدخول الاستعماري، قد مر بأربعة مراحل أساسية يصنفها كالآتي: مرحلة الحكم الجمهوري الأوليغارشي والديمقراطي، مرحلة حكم الشيوخ أو الـ "إمغارن"، مرحلة حكم القواد الكبار أو ما يعرف بسادة الأطلس وأخيرا مرحلة حكم المخزن.
ومن خلال مقاربة سوسيوتاريخية لعلاقة السلطة المخزنية بالمجتمع في مغرب ما قبل المرحلة الكولونيالية، فقد شكلت القبيلة مجال نفوذ مشترك بين قوى سياسية ثلاثة: سلطة الزاوية، سلطة العامل أو القائد المخزني، سلطة المجالس القبلية. ولاشك إن كل هذه السلط والأنظمة لها خصوصيتها الخاصة في العلاقة مع أنماط إنتاجها، وتختلف عن الأسلوب الآسيوي، وأيضا عن الفيودالي. وبالتالي لا يمكن أن نأطر المغرب داخل خطاطة الأسلوب الآسيوي لأن مجتمع المغرب فيه كثير من الأنظمة الاجتماعية المتعددة التي تشكل المجتمع المزيج. على أية حال، لم يتفق الجميع مع هذا الارتباط بشأن العلاقة بين نمط الإنتاج الآسيوي والقائدي الذي يميز النظام المغربي في القرن التاسع عشر.
في نقد الخطاب العقائدي في إطار ابستمولوجية السوسيولوجي بول باسكون:
بعد استعرضنا لمختلف أنماط الإنتاج ومقارنتها بأنماط السائدة في المجتمعات المغربية، يبقى ضرورة وضع الدراسات التي ناقشت وعالجت نفس الموضوع أمام سلطة الابستيمولوجية لإصدار موقف علمي موضوعي حول مدى صحتها وحقيقتها، ومدى تطابقها واختلافها بصياغة تسلسل سوسيولوجي منهجي منسجم لرصد كل أنماط الإنتاج السائدة في المجتمع المغربي المركب والمزيج في إطار معرفة ما إذا كان القائد هو ماهية الظاهرة الاجتماعية المغربية وحقيقتها أم فقط هو الجهة التي ينظر إليه في هذا النظام. بل ويجب كذلك تنقيحها من الخطاب السياسي لإعطاء صفة العلمي في بلاغته، الشيء الذي يفرض بذل مجهود كبير للتفكير علميا كما يقول دائما صاحب "نطام فيودالي أم نظام قائدي بالمغرب"، خصوصا وأن خط السوسيولوجيا كانت في كثير من الأحيان موضوع مجابهات وصراعات خاصة ومتميزة، كما يرى الباحث السوسيولوجي المغربي محمد جسوس.
ومما لاشك فيه، فإن السيوسيولوجيا ارتهنت منذ نشأتها الأولى بمصدرين أو اختيارين متناقضان، بين دعاة أوغست كونت وبين الطرح الماركسي، يقول بول باسكون: "لا يوجد بالنسبة للعقائدي سوى اختيارين إثنين: إما شرح (أقوال) ماركس والتعليق عليها –بمعنى تفسيرها- وإما التموقع في معسكر المناقضين الذين تتعدد قناعاتهم". طبعا باسكون لا يرفض ولا يشك في المنهجية الماركسية إنما يحاول استخدامها وفقا لإمكاناته، وإن كانت كغيرها لا تحل كل شيء برأيه.
وإذا كان الباحث المغربي محمد جسوس في مقال 'عقائدي' له حول "وضعية البحث السوسيولوجي بالمغرب" يتسأل حول ما إذا كان بالإمكان بناء معرفة سوسيولوجيا في إطار مجتمع سياسي، ثقافي، إيديولوجي، يتسم في كل جزء منه بالعداء ليس فقط للسوسيولوجيا، ولكن لكل ما يمت للعلم والعقلنة بصلة، فإن بول باسكون، ينتقد بشدة هذا الطرح، كما سنرى، بل يذهب إلى أبعد من هذا، حين يقول: "بأن الأمر لا يتعلق بعلمين بل بخطابين ايديولوجيين لا يتوقفان عن تغذية آرائنا المسبقة ومفترضاتنا التي يجب الدفاع عنها باستمرار للحفاظ على توتر الجهد والشك". معنى هذا، يجب زعزعة هذه العقائد التي تدعي امتلاك الحقيقة وإلى احتكار للتأويل. وطبعا تجاوز هذه الثنائيات يتم عبر تبني مقاربات متعددة الأبعاد، حيث يقتضي ذلك التعدد النظري الذي يفيدنا في إنتاج سوسيولوجيا مرنة قابلة للتكيف وقادرة على المواكبة ومؤهلة لتحليل وتفسير تبدلات المجتمع.
يشير بول باسكون في مقام آخر، إلى انحراف يربك العلوم الاجتماعية بصفة عامة، وهو الانحراف الذي يجعل الحكم الذي نطلقه على الأفكار غامضا، وذلك عن طريق آراء مسبقة نُكونه عن الشخص، الذي يعبر عنها أو عن انتمائه المفترض وغيره. وبطبيعة الحال، هذا يذكرنا بقواعد المنهج لدوركايم التي يجب دائما استحضارها في الحقل السوسيولوجي كمناعة لا بد منها ضد "النزعة العقائدية" و"النزعة الضلامية" على حد تعبير بول باسكون.
وفي سياق آخر، يدعو الراحل المغربي بول باسكون إلى عولمة العلم -إذا صح تعبيرنا هذا- بمناهج علمية، وذلك بعدم الانغلاق داخل الجماعة التي ننتمي إليها في حبس وجهات نظرنا وتصورتنا فقط بالفروع المعرفية والنظريات السائدة في مجتمعنا، لأن بذلك سيكون "نهاية المعرفة" في رأي بول باسكون. وإنه، يجب كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار لمختلف وجهات النظر والتفتح على مختلف المدارس الفكرية العالمية والاستفادة من الفكر السوسيولوجي كله، دون تجاهل مساهمات السوسيولوجيين الكلاسيكيين أمثال كارل ماركس ودوركايم وبارسون...الخ.
لكن في المقابل، لابد لنا من مواكبة تلك الأطروحات التي تأسست على أنقاض تاريخ الجدل السوسيولوجي بين الوظيفية والبنيوية الوظيفية والاستفادة من أزمة الماركسية، حيث برز الآن توجه نحو التداخل النظري أو التعدد النظري، وذلك بالتقاط المقاربات الأجود مرودية من الناحية المعرفية، والاستفادة من هذا المنبع المعرفي في صياغة محاولات لأطروحات وأبحاث نظرية جديدة، وتوظيفها من الناحية الابستمولوجيا لإعطاء مشروعية علمية.
وهذا في رأينا، سيقلص من فجوة الأزمة التي تعيشها السوسيولوجيا، وسيساعد على فهم الإشكالات والأسئلة الكبرى التي تطرح من داخل الحقل السوسيولوجي، كما هو حال إشكال موضوع عرضنا هذا.
وهكذا، فمن خلال مختلف المقاربات النظرية والمنهجية والابستيمية الأكثر تخصيبا للمعرفة السوسيولوجيا نصل إلى التوجه الصحيح، الذي ينبغي للسوسيولوجيا أن تأخذه إزاء الرهانات الاجتماعية التي تواجه المجتمع. وفي هذا، يجب إغناء التأمل النظري المرتبط بالفكر السوسيولوجي المغربي، بإغناء تنظيره من دون التفريط في معطيات الواقع الاجتماعي أي بدون تعسف في استخدام المعطيات أو تسييسها بمبررات سياسية أو وطنية أو دينية... معنى هذا، يجب أن يكون رهين بتأسيس أفق ابستيمي واضح ودقيق ينسجم مع القوانين الاجتماعية العامة التي ثبتت صدقيتها، الذي يستلزم هذا طبعا تحقيق ذلك الحد الأدنى من القطيعة تجاه الذات وتجاه الجماعة التي ننتمي إليها للتوصل إلى الموضوعية والعلمية.
واضح إذن، أن على كل باحث، كيف ما كان، ينبغي عليه أن يتخلص من معالجة هذا الإشكال المتمثل في إرثه الثقافي والعقائدي، أن يقوم بعملية حفر معرفي للذات وإقامة مسافة أو حاجز بين الذات والموضوع، وهذه المسافة يجب أن تكون نقدية متحررة من عبودية وضعية وجاهزية الأفكار، حيث إنه في هذه العملية النقدية يسقط الفكر العقائدي، ونكون بذلك بعيدين عن الدوغمائية وأحادية الفكر والنمطية. وبالتالي أن ننطلق بأن ذواتنا قابلة للنقد ولا تمتلك الحقيقة الكلية المطلقة وأن ما تنتجه من المعرفة قابل للإشكال، قابل للاعتراض، أو أن الآخر متوهم وعلى ظلال إلى غير ذلك، وهذا يرجع إلى أننا لا نستطيع أن ننسلخ من ذلك الإرث العقائدي الذي يرثنا.
هكذا، يجب محاربة النزعة العقائدية والخطاب السياسي وتفادي الاختزال والتعميم، وبالطبع، فالوصول إلى هذا المطمح العلمي يقتضي الالتزام إلى درجة الأورثودوكسية بمجموعة من القواعد السوسيولوجية، فعلم الاجتماع من حيث هو تفكير في المجتمع وأنظمته يستلزم التباعد، أي يستلزم تحقيق الحد الأدنى من القطيعة تجاه الذات وتجاه الجماعة، فالموضوعية عند بول باسكون تعد شرطا غير قابل للتفاوض في رحاب السوسيولوجيا، فهي الضمانة الممكنة لأصالة ونزاهة المنجز السوسيولوجي، حتى لا يكون هناك تلويث الاستدلال عن طريق القدح الطبقي والوطني والعقيدي كما تعرض له الأب الروحي للسوسيولوجيا المغربية بول باسكون بصدد دراساته حول الأنظمة الاجتماعية في المجتمع المغربي المزيج، الذي كان في كثير من المقاربات ضحية هذا النوع من الخطاب الذي يدعي العلمية.
أكديم
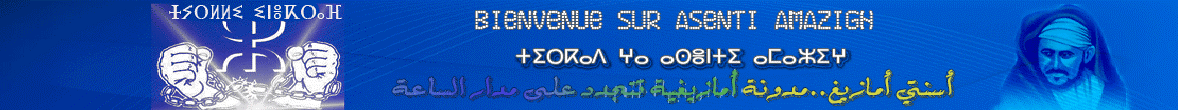








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق